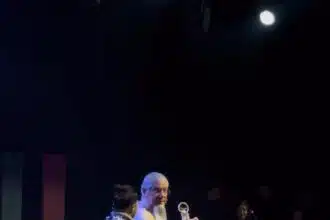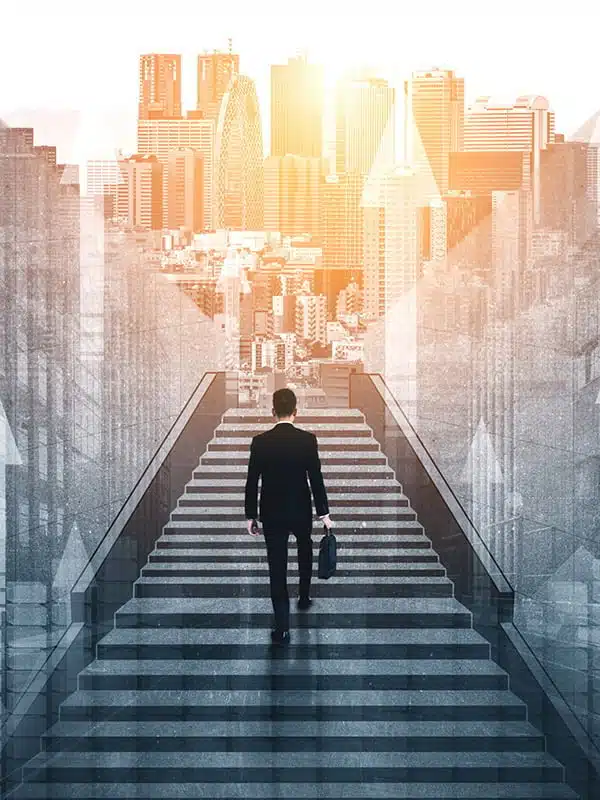روماف – رأي
تشهد السويد حالياً مناقشاتٍ واسعة، وعلى مختلف المستويات، في وسائل الإعلام وفي أماكن العمل، وفي اللقاءات بين الأصدقاء، وعلى موائد الطعام، سواء التي تجمع بين الأصدقاء أم بين أفراد الأسر، حول مستقبل المجتمع السويدي بصورة عامة، ومستقبل العلاقات بين السويديين الأصليين إذا صحّ التعبير، والمهاجرين من الذين حصلوا على الجنسية السويدية، أو الذين ولدوا في السويد من أبوين مهاجرين وحصلوا على الجنسية، والمهاجرين المقيمين ممن ينتظرونها وفق قواعد معينة، ستصبح أصعب وأكثر تعقيداً، نتيجة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة التي تشكّلت بعد انتخابات سبتمبر/ أيلول الماضي البرلمانية، وأسفرت عن أغلبية ضئيلة لصالح ائتلاف يمين الوسط واليمين المتشدّد الذي حصل على 176 مقعداَ في البرلمان، مقابل 173 لصالح أحزاب المعارضة: الاشتراكي الديمقراطي والوسط والبيئة واليسار.
ورغم أن الحزب الليبرالي، من الائتلاف الحاكم، ربط مشاركته في الحكومة بعدم مشاركة حزب ديمقراطيي السويد المتشدّد في موضوع الهجرة والمهاجرين، إلا أنه اتفق معه، إلى جانب الحزبين الآخرين في الائتلاف الحاكم، المحافظين والديمقراطي المسيحي، على برنامج سياسات الحكومة في مختلف الميادين خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بهدف تمكين الحكومة من الحصول على الثقة في البرلمان. وقد أثار هذا البرنامج، ويثير، انتقاداتٍ كثيرة.
أما القضايا التي يركّزعليها البرنامج المعني فهي تخصّ الأوضاع الداخلية السويدية بالدرجة الأولى، ومنها قضايا التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والهجرة والجنسية، والقانون والنظام، والأمن ومكافحة الجريمة. واللافت في هذا البرنامج أن نصفه بالضبط (30 من أصل 60 صفحة يتألف منها) قد خصّص لقضيتين: الهجرة والمهاجرين، وتشديد القوانين والإجراءات، لمكافحة الجريمة المنظمة من العصابات التي تتمركز أساسا في المناطق المهمشّة التي تسكنها غالبية من المهاجرين.
يفتح برنامج الحكومة الجديدة في السويد الأبواب أمام إمكانية سحب الإقامات من الأسر التي يرتكب فرد من أفرادها جرائم كبرى وفق القانون
في ما يتصل بالقضية الأولى، هناك توجّه واضح إلى الحدّ من أعداد اللاجئين والمهاجرين إلى أدنى حدّ ممكن؛ ليصبح عدد الذين كانت السويد تستقبلهم سنوياً ضمن حصتها المتفق عليها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من 5000 إلى 900 لاجئ. وهناك مقترحات وإجراءات متشدّدة في موضوع استقبال المهاجرين، وحزمة من الشروط الصعبة تحدّد قواعد منح الإقامات الدائمة والجنسية، تشمل اشتراط تعلّم اللغة والقدرة على الإعالة الذاتية، ورفع عدد السنوات المطلوبة للحصول على الجنسية، بالإضافة إلى أهمية احترام معايير المجتمع السويدي.
بالإضافة إلى ما تقدّم، يفتح برنامج الحكومة الجديدة الأبواب أمام إمكانية سحب الإقامات من الأسر التي يرتكب فرد من أفرادها جرائم كبرى وفق القانون السويدي، بل وحتى طردها، وذلك لإخفاقها في تربية أبنائها بموجب ما ذهب إليه أصحاب الإقتراح. كما يطرح البرنامج المعني فكرة إمكانية سحب الجنسية من مرتكبي الجرائم الكبرى، إذا ما كانوا يمتلكون أكثر من جنسية. وهناك توجّه نحو خفضٍ حادٍّ في نسبة المساعدات الإنسانية التي تقدّمها السويد للمجتمعات أو الدول المحتاجة.
وعلى الصعيد القانوني والإجراءات الرادعة التي تعمل الحكومة على تطبيقها، للحد من نسبة الجرائم، فهي تشمل زيادة مدة عقوبة الحبس، وإلغاء التسهيلات التي كانت تُمنح لليافعين من المحكومين بالجرائم، ودراسة إمكانية أن يقضي المدانون مدة عقوبتهم في سجون خارج السويد. هذا بالإضافة إلى الإجراءات التي ستسمح بمراقبة المتهمين بمختلف الوسائل، وتعديل القوانين لتسمح بحجب هوية الشهود في المحاكم ضماناً لسلامتهم، وتشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم.
لم يعد التوجّه الشعبوي مقتصراً على حزب ديمقراطيي السويد، بل يشمل أحزابا سويدية وأوروبية
كل هذه الإجراءات المتشددة المقترحة وغيرها مبنيةٌ على ارتفاع نسبة حوادث القتل التي باتت بالفعل ظاهرة تقلق الجميع في السويد؛ وهي، في غالب الأحوال، نتيجة الصراعات وحالات الثأر بين عصابات الجريمة المنظّمة التي تعمل في ميدان الممنوعات (المخدّرات، الأسلحة، الدعارة)؛ وهي إجراءات تلقى تعاطفاً عاماً في المجتمع السويدي، نتيجة اتساع نطاق تلك الحوادث وكثافتها، والآثار التي تنعكس سلباً على الأفراد والأسر والمجتمع. واللافت تحوّل موضوع ارتفاع نسبة جرائم القتل وانتشارها إلى مادّة رئيسة في الحملات الدعائية التي يقودها حزب ديمقراطيي السويد، بهدف التركيز على المهاجرين، والدعوة إلى التشدّد الصارم في موضوع الهجرة. وهي حملاتٌ تؤدّي إلى تفاقم النزعة العنصرية التي تغدو مادة للتجييش، بهدف زيادة القاعدة الانتخابية، خصوصا في مناطق الريف، وبين متوسطي الثقافة، وذلك من خلال إعطاء الوعود بتحسين مستواهم المعيشي، ومعالجة سريعة للمشكلات التي يعانون منها، وفي المقدمة منها مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، المشكلة التي تفاقمت بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
والجدير بالذكر هنا أن هذا التوجه الشعبوي لم يعد مقتصراً على حزب ديمقراطيي السويد، بل يشمل أحزابا سويدية وأوروبية. وهذا ما يؤكّد مجدّدا خطورة النزعة الشعبوية على الأنظمة الديمقراطية بصورة عامة، ولا سيما في ظروف عدم وجود قيادات ذات كفاءة مؤثرة، ملتزمة بالمبادئ أكثر من سعيها إلى السلطة. وقد تعزّزت هذه النزعة مع وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، إذا بات قدوة لأحزاب وتيارات شعبوية أوروبية كثيرة، غربية وشرقية.
وما يمنح حملات الشعبويين السويديين الدعائية قسطاً كبيراً من القدرة الإقناعية يتمثل في سلوكيات بعض المهاجرين ومساعيهم إلى استغلال مزايا نظام الرفاه عبر أساليب ملتوية منافية للقوانين. ورغم أن نسبة هؤلاء ضيئلة قياساً إلى العدد الإجمالي للمهاجرين، إلا أن اليمين المشتدّد يستغل ما يحصل في مساعيه لتكريس ثقافة “نحن” و”هم” عبر تضخيم المشكلة، وتجاهل الجهود الإيجابية الكبيرة التي ساهم بها المهاجرون وأبناؤهم، ويساهمون في مختلف الميادين الإنتاجية والخدمية والصحية والتعليمية، وحتى البحثية والثقافية والإعلامية. غير أنه، في جميع الأحوال، لا يمكن فصل ما يجري في السويد عما يحصل في دول أوروبية عديدة، مثل إيطاليا والمجر وفرنسا، حيث يتصاعد المدّ اليميني المتشدّد تجاه المهاجرين. ومع ذلك، هناك آمال كبيرة معقودة على قوى سياسية ومجتمعية وثقافية سويدية عديدة، والأوروبية بصورة عامة، التي تواجه نزعات اليمين المتشدّد بوضوح وعقلانية وجرأة. ومن المتوقع أن تستفيد هذه القوى من وصول ريشي سوناك إلى موقع زعيم حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في بريطانيا، لتقدّم مثالاً حياً، يؤكّد أهمية الجهود الإيجابية التي يمكن أن يساهم بها المهاجرون في خدمة مجتمعاتهم الجديدة.
واقع يستوجب معالجة دولية جدية تبدأ بوضع حد لأنظمة الاستبداد والفساد عبر دعم تطلعات شعوبها التي تريد الخلاص من الظلم والقمع
يعاني الوضع العالمي الراهن من الخلل بصورة عامة، وينذر بصعوباتٍ كثيرة، بل وبكوارث، وذلك بفعل مساعي الدول الاستبدادية لفرض نفوذها على الشعوب تحت شعار إعادة النظر في النظام العالمي من جهة، وعدم استعداد أنظمة ديمقراطيةٍ كثيرة لمساعدة الشعوب التي تعاني من الاستبداد المتوحش والفساد المنفلت من جهة أخرى، فالأنظمة الاستبدادية في مختلف أنحاء العالم ترى أن مصلحتها تنسجم مع الأنظمة الدكتاتورية المؤثرة على المستويين العالمي والإقليمي، وهي الأنظمة التي تعمل على بلوغ أهدافها عبر استخدام العنف، وسياسة تفجير المجتمعات والدول وتعطيلهما، وتطوير ترسانتها من الأسلحة الفتاكة، والتهديد حتى باستخدام النووية منها.
ويُشار في هذا السياق إلى دور كل من روسيا وإيران في زعزعة أوضاع المجتمعات والدول في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، وحتى في أفريقيا وأميركا اللاتينية. والمثال السوري هو الأوضح في هذا المجال، فسورية عانت، وما زالت تعاني، من تدخّل الدولتين إلى جانب سلطة بشار الأسد في حربها على السوريين مناهضي استبدادها وفسادها؛ وكان من بين نتائج ذلك تهجير ملايين السوريين، وتوجّه قسم كبير منهم نحو الدول الأوروبية، وفي المقدّمة منها ألمانيا والسويد، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم أزمة المهاجرين وتفاعلاتها في أوروبا بصورة عامة، وفي السويد تحديدا منذ عام 2015، وهي الأزمة التي تمحورت حولها الدعاية الانتخابية لليمين المتشدّد الذي استفاد من الأخطاء التي كانت، وحصل بفعل ذلك على مزيد من الأصوات، ليصبح الحزب الثاني من جهة عدد مقاعده البرلمانية، فلو كانت الأوضاع مستقرّة مقبولة في سورية وغيرها من دول المنطقة، لما كانت هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين في السويد وألمانيا وبقية الدول الأوروبية؛ هذا مع العلم أن هذه الدول تحتاج بالفعل إلى قوىً عاملة شابّة في مختلف الاختصاصات.
ما يرغم الناس على الهجرة، والاستعداد لتحمل أهوال طرقها، وتبعات نتائجها، هو غياب الأمن والأمان، والحد الأدنى من مقوّمات العيش المقبول، وذلك كله في ظل أنظمةٍ مستبدّة فاسدة، أوصلت القسم الأعظم من السكان إلى ما دون مستوى الفقر. هذا هو واقع الحال في سورية ولبنان والسودان وليبيا والعراق واليمن ودول أخرى كثيرة في مختلف القارّات. وهو واقع يستوجب معالجة دولية جدية تبدأ بوضع حد لأنظمة الاستبداد والفساد عبر دعم تطلعات شعوبها التي تريد الخلاص من الظلم والقمع، والمثال الإيراني اليوم هو الأوضح. أما الاستمرار في نهج التعاون والتعامل المتبع راهناً مع الأنظمة المعنية، وغضّ النظر عن جرائمها ضد شعوبها وشعوب غيرها من الدول، فهذا فحواه مزيد من التداعيات والانهيارات.