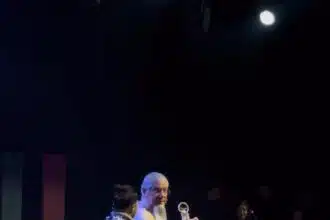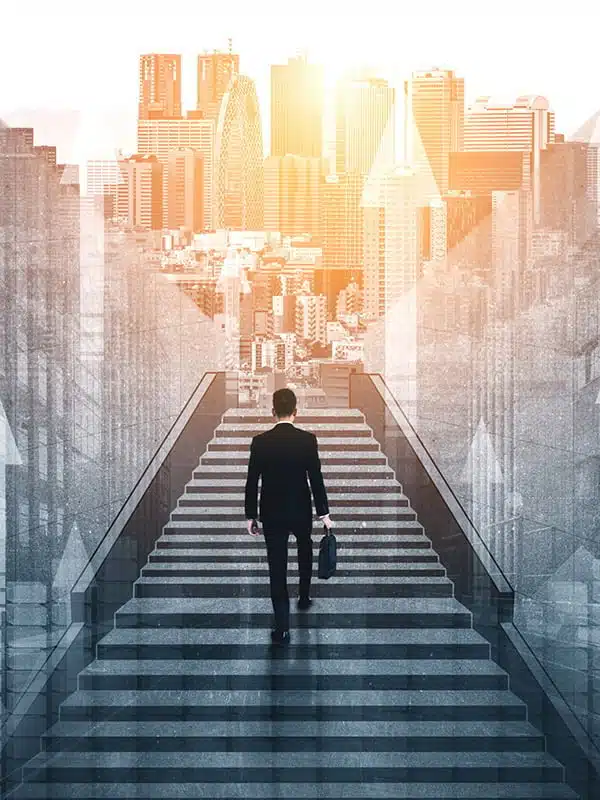روماف – رأي
كشف انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتوافرها بين أيدي المليارات، في هذا العالم، النقاب عن بروز ظواهر مستحدثة، جد خطيرة، لطالما كانت- من قبل- ضمن أطر جنينية، فردية، محدودة التأثير، ضيقة الأمداء، شاذة، فيما يخص الآثار الخطيرة الناجمة عن عدم الأهلية للانتماء إلى العمارة الكونية لدى بعض الشذاذ الذين بات بعضهم يرى ذاته في موقع: وزير إعلام، بعد أن أصبح في إمكان جهاز صغير- بحجم كف اليد- ألا وهو جهاز” الهاتف الذكي” قادراً على أن يؤدي وظائف متعددة، خارج وظيفته التي طالما عرف بها، قبل أن يدخل مرحلة مصطلح الذكاء، حيث يلاحظ في زمن انتشار الحروب والفتن، والقتل والدمار، استهداف النسيج الاجتماعي، عبر التسلل من خلال أفراد خارجين عن القانون، يستخدمون هذه التقانات ما بعد الحداثية لأغراض خبيثة، توازي أو تبزُّ في حقيقتها آثار السرطان، أو أسلحة الدمار، باعتبار الإعلام أداة راقية، مهمة. فعالة. ضرورية، ومن حق جميعنا استخدامه، ضمن حدوده، وشروطه، وقوانينه، بما من شأنه أن يخدم رسالة الوئام، ونشر ثقافة السلام بين المحيط. المحيط كله، لا التعامل معه وفق سلوك- قاطع الطريق- أو البلطجي، إذ إننا غدونا- الآن- أمام ظاهرة كونية لابد من وضع حد لها. من بين هذه الظواهر المدمرة للفرد والمجتمع، والتي قد تدفع إلى تربية أوساط واسعة على ارتكاب الجريمة، تنطع بعضهم إلى إيذاء من هم مقرَّبون منهم، نتيجة ردود فعل ما، أو نتيجة تكليفهم، بمثل هذه المهمات، في ظل استسهال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما لا يعد ضمن نطاق حرية الإعلام، أو النقد، بأشكاله، بل بما يدخل في نطاق الشخصنة، وطعن الآخرين، لاسيما من لدن من قد يعدون من مقربيهم. من ضمن محيطهم الاجتماعي، مستثمرين التزام- كثيرين- ممن تتم الإساءة إليهم بعدم الرد. بالسكوت. بالتعالي على ما يتم، من دون معرفة الآثار التي قد تلحقها هذه الإساءات بهم، وبذويهم، لهذا السبب أو ذاك، والتحصن وراء الروابط الاجتماعية التي قد تعيب اللجوء إلى-القانون- أو نزول الطرف المتضرر إلى درك استخدام طرائق هذا الأنموذج الذي ينال منه، انطلاقاً من هذه الاعتبارات وغيرها! وطبيعي، أن من يقبل أداء هكذا مهمات، لاسيما ضد أناس ذوي حضور اجتماعي، أو سياسي، أو ثقافي، ليس في النهاية إلا ضحية نمط تفكير، أو نمط علاقات، وهو-هنا- في حاجة إلى الرأفة، لاسيما عندما لا يكون لهذا الأنموذج تاريخ في مواجهة آلة الخطأ، في إطار الإعلام، أو الموقف، وقد يبدو الأمر أكثر إيلاماً عندما لا نجد له أي دور مشهود في اتخاذ الموقف من الطغاة، بل حتى ممن هم خارج محيطهم الاجتماعي. بلداً، أو قومية، إذ يرضخ لمن بيده أية سلطة، أو أي صاحب سطوة، بينما يستقوى على من هم من عداد مقربيه، حتى في حدود الرد الهادىء، وهو حق طبيعي له، أنى تمت الإساءة إليه، وهذا ما يذكِّر بشخصية من يصب جام غضبه على أسرته، أنَّى كان بينهم، بيد أنه يجبن. ويخنع، في حالة ذل، مشينة، حتى في الدفاع عن ذاته، في حضرة الأغراب الذين يؤذونه، أو يؤذون مجتمعهم، أو الإنسانية! بعيداً، عن افتقاد هذا الأنموذج لخصيصة الشهامة، والشجاعة، إلا عن بعد، فهو في أعماقه، يعاني من مشكلة- جبن- حقيقي، إلى درجة عدم المرافعة عن الذات، ناهيك عن معاناته من- مركب نقص- واضح، يدفعه لتقديم ذاته، في صورة يرسمها له خيال مرضي، في مواجهة القريب الذي طالما لا يتوقع بدور ردة فعل من لدنه باتجاهه، وهذا ما قد نقع على حالات له، عبر الفضاء الافتراضي، وما كان لهؤلاء السقوط في شباك هذه الحالة، لولا أنهم وجدوا في هذا الفضاء ملاذاً لهم، يحقق لهم العملقة ومحاولة التعويض عن الجبن الداخلي، مقابل الانقياد وراء- الحالة- الوحشية، غير الإنسانية، في مواجهة الآخر، من دون أي مسوغ يذكر؟! وإذا شخصنا، أمام أعيننا أمثلة ما، لحالات شاذة، خارجة على القانون، تنصرف إلى إلحاق الأذى بالقريب، وتتحاشى المتجبر، القوي، في فضاء اختباري ميداني، فإننا نحيل هذا النموذج إلى سؤال صريح و واضح، حول دوره المشهود له، في مواجهة ثقافة احتلال، أو اعتداء عليه، أو على من حوله، من قبل هذا الطاغية، أو ذاك، لنتأكد، بأن حالات التطاول على الآخرين، من دون أية أسباب مسوغة، عبر الفضاء الافتراضي، إنما تعاني من أزمة ما. أزمة داخلية، ولعل عدم اللجوء إلى القانون، من قبل من يقع عليه الحيف يكمن وراء مفاقمة هذا الخطر الداهم الذي يجب أن نقرع الأجراس، للتخلص منه، باعتباره، لا يقل وطئاً عن: حالة كورونا التي استنفرتنا، بل ولا يقل عن مواجهة جريمة: قتل، لأن هؤلاء، سواء أأدركوا، ما يفعلون، أم لم يدركوا ذلك، إنما يمارسون جريمة منظمة أو عشوائية، بحق مجتمعهم، ومكانهم وإنسانهم، وجيرانهم في العمارة الكونية!
|  |
 |