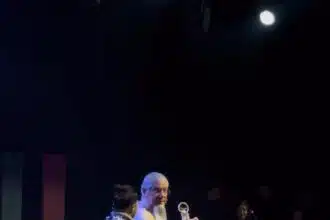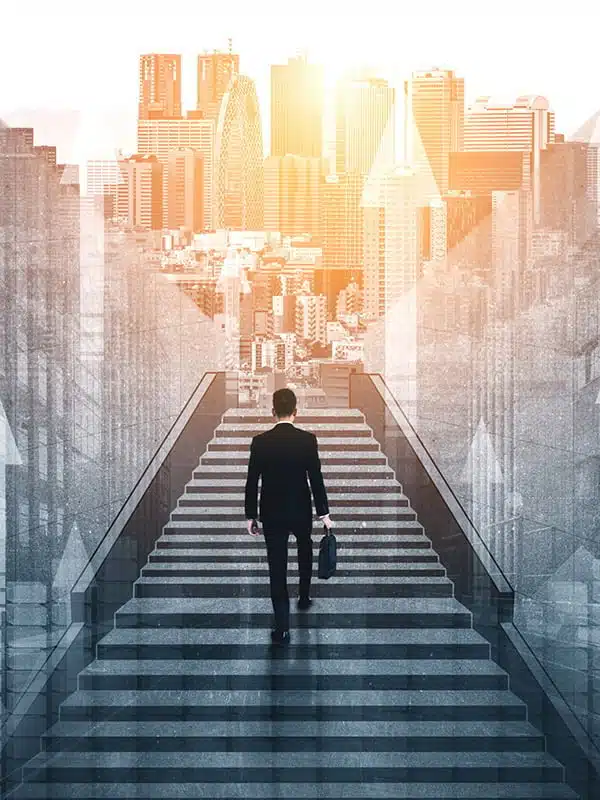روماف – نصوص
وسط صفين من الوجوه الباسمة والزغاريد المتصاعدة وكاميرات التصوير، تقدمنا ببطء، خلف الزفة الاسكندراني.
بيسراي أتأبط ذراعه الأيمن، وأقلّده في توزيع البسمات، بينما رأسي يدور كالمروحة، بحثاً عن شخصٍ أعرفه.
جموعٌ غفيرةٌ…رجالٌ منصوبي القاماتِ سمر البشرة تنافس جلابيبهم وعمائمهم بياض الحليب…أطفال وفتيات يانعاتٍ حالماتٍ يطالعون فستاني الأبيض بانبهارٍ وفضولٍ…. نساءٌ مليحاتٌ فاتناتٌ موشحاتٌ بثيابٍ سودانية، حرائر صفراء وحمراء، وتواتل زاهية الألوان مطرزة بخيوط من ذهبٍ يخطف بريقها الأبصار….والكل يردد:
أقروا الفاتحة لأبو العباس…… يا اسكندرية يا أجدع ناس
والفاتحة التانية لأبو الدرار……. واللى يعادينا يولع نار
والفاتحة الثالثة لسيدى ياقوت …..واللى يعادينا يطق يموت
وبينما رأسي يواصل التلفت كمروحة وعيناي تتفرسان في وجوه الناس، تواصل قدماي التسكع بجوار عريسي في أثر الزفة المتجهة نحو وسط الصالة، حيث تقف الفنانة السودانية بتأهب.
بإعجاب ودهشة أتأمل ملاحتها والهيبة التي تحيطها؛ ليبهرني ثوبها الحريري الأحمر المطرز بخيوط ذهبية، ونقوش الحناء العاكس سوادها لبريق الحلى الذهبية المزينة لمعصميها وأصابعها المكتنزة. وأثناء تجاوزنا إياها ببطءٍ، ألمحها تمسحني بنظرةٍ فاحصة ابتداءً من إكليل الذهب المتوسط لشعري، مرورًا بباقة الورد الممسوكة بيدي اليمنى، وانتهاءً بزيل فستاني الأبيض.
نترك الفنانة وراءنا ونواصل التقدم إلى وسط الدائرة.
يجتاحني شعور بالانقباض لحظة وتوقف الزفة وانطفاء الأنوار.
تنفض الجموع من حولنا، وتُدار أغنية “My heart will go on”، التي غنتها سيلين ديون في فيلم “تايتنكTitanic-“.
يشدني عريسي إلى صدره، ويحاول جعلي أتناغم مع تمايلاته البطيئة لأداء رقصة الـ “Slowly”، بدون فائدة؛ بسبب شرودي مع تساؤلاتي المريرة عن سبب تغيب أهلي في مناسبة زواجي التي انتظروها بفارغ الصبر.
لحظاتٌ عصيبةٌ تمر، أرقص فيها برعونة، قبل أن تُضاء أنوار كشافات الصالة، لتمتزج زغاريد الفرح بصفافير الحماس، بينما أنا وسط هذا كله، لا أهتم لشيء سوى العثور على وجهٍ أعرفه.
تتوقف موسيقى فيلم “تَايْتَنِكTitanic-“؛ فيصدح صوت الفنانة المتأهبة بموالٍ يردده الكل وراءها:
الليل الليل العّديل والزين …والليلة العديلة ويا عديلة الله
بسم الله ابتديت قولي السَّمِّحْ والزين
والقول ماهو داير البكتب ويِقرا
يشغلني ذهولي من فرح الجموع وانسجامهم مع الفنانة عن همي لبرهة قبل أن تغزوني تساؤلات أخرى أشد مرارة:
– أيفرحون ويتجاهلون شعور العروس بالحزن والغربة؟ أم أنهم لا يلاحظون بأنني وحيدة…كئيبة… غريبة بينهم بلا أهل أو أصدقاء؟
وأخيرًا، تُنهي الفنانة موالها…وتبارك بصوت جبلي:
– ” ألف مبروك للعروسين معتز الجَعَلي وشمس العَشْري”
يضغط عريسي على يدي بحنان؛ فأفيق من شرودي وألتفت إليه لأهديه ابتسامة مصطنعة، قبل أن نواصل التقدم عند صدوح موسيقى سودانية، مزيج آلاتٍ صاخبة (طبول وكمنجات وأورغ ودلوكة)؛ متوجهين نحو الكوشة المزينة بالورود.
وما أن نأخذ مجلسنا، حتى تداهمنا الجموع لتقديم التبريكات؛ ليجتاحني تشتت وشعور بالاختناق من فرط تناوب النساء المعطرات بالخمرة السودانية وبخور الصندل على تقبيل وجنتاي، اختناقًا ينسيني التفكير في أهلي. ولا ينقذني من تلك الحشود وزخم الروائح، إلا صوت الفنانة الجبلي وهو يفتتح أغنية الفَزَع:
العُوقْ الصفوف ورِهاب…أنا قاعد ليو مِلازم الباب
الدَّايِرْني يِجِيني عَدِيلْ
بفضولٍ التفت لأسأل عريسي عن سر تلك الكلمات التي جعلت الجموع تفزع نحو الدائرة؛ فأتفاجأ بانسلاله من جواري برفقة مجموعة شباب أحاطت به أياديهم، وسحبته سحبًا نحو حلقة الرقص. أظل فاغرة الفاه أراقب بدهشةٍ الوجوه الغريبة تتكدس في الدائرة؛ لينتفض قلبي عند رؤيتي أخيرًا لوجه أعرفه: تسابيح.
بلهفة أتابع أخت عريسي، تتقدم بزهوٍ في ثوبٍ أصفرٍ مطرزٍ بخيوط بنفسجية، جلب لذاكراتي فستان ميسم الذي اشترته لحضور زواجي…تصيبني غصة عند إدراك أن أختي لم تحضر لتشاركني الفرحة بزواجي الذي انتظرته طويلًا…. أراقب تسابيح تشق طريقها وسط الجموع لتصل لأخيها (عريسي) وتسلمه كرباجًا طويلًا بمقبض مزخرف بالجلد الأحمر والبني….يقشعر بدني عند تعرفي على سوط العَنَجْ؛ لتستعيد ذاكرتي الآثار الشبكية على ظهر معتز، التي أراني إياها ذلك الخميس في سيارته أثناء وقوفنا أمام محطة “روض الفرج” بدوران شُبْرا.
تلتمع عيون الشباب حماسًا…ويتسابقون لتعرية ظهورهم استعدادًا للجلد بالسوط، رافعين أصواتهم مع الفنانة:
قَطَر الموت بِجِيك يا خَيْ… شِايْلَ المُر مَسُوح وشَرَاب
الدَّايِرْني يِجِيني عَدِيلْ
في خيلاءٍ، يتقدم عريسي ممسكًا بـ”سوط العَنَجْ” بحماسٍ …يقترب من شباب “الرَكْزَة ” المتلهفين لإظهار شجاعتهم؛ فيتحول ذهولي إلى اضطراب وتسارع خفقات قلبي أثناء متابعتي لخطوات عريسي بأنفاسٍ مكتومةٍ. أكاد اختنق عندما يهوي بالسوط على ظهورهم العارية واحدًا تلو الآخر: بالترتيب من اليمين إلى اليسار، دون أن يرمش لأحدهم طرف.
يتفاقم شعوري بالغثيان؛ فأغمض عيني لكيلا أشاهد المزيد…وأعدُ إلى العشرة املاً في استعادة رباطة جأشي….ثم أفتحهما ببطء، لألاحظ انسجام واستمتاع الجميع مستمتع بمنظر ذلك الطقس البربري: عادة “البطان”
أقرر الهرب من ذلك الجو الخانق. لكن قبل أن تطأ قدمي سيراميك أرض الصالة، أسمع صوتًا مألوفًا يستوقفني:
– رايحة فين؟
انتفض بهلع ثم أعود أنكمش في مكاني…ثم ألتلفتْ لأتفاجأ بمريم، تطالعني بابتسامةٍ ماكرةٍ، ووميض فرحً في عينيها، يقول شامتًا: (لقد ضبطتك متلبسةٍ أيتها العروس الغافلة).
بنظرة لومٍ أحدجها، وبنبرةٍ غاضبةٍ أعنفها على تغيبها عن حضور زفة فرحي…تأمرني بالهدوء؛ فيتضاعف غيظي من ابتسامتها غير المبالية…أوبختها على عدم مراعاة صداقتنا وتجاهل حاجتي لرؤيتها بجواري في يومٍ مثل هذا؛ فتعلل ببرودٍ: “ها أنا ذا أمامكِ الآن”….يشتد غيظي؛ فأتجاهله لأسألها: أين أهلي؟ …..تشير برأسها إلى وسط الدائرة حيث ميسم تتوهجٍ وسط الجموع كتوهجِ البدر ليلة التمام، متمايلةً بفستانها الأصفر الزاهي الراسم لتفاصيل جسدها الممتلئ، محركةً ليديها المخضبة بنقوش حناءٍ والمزينة بأساور ذهبية في كل اتجاه، بينما شفتيها تردد بانسجام مع الفنانة:
حَمْد القوز ومُرْ يا خَيْ….ومِحْوَر للبِطُقُو الكَيْ
الخَلاَّ الرِجال تِنْمَاصْ….أنَا قاعِدْ لِيوْ خَلَفْ كِرْعَيْ
الدَّايِرْني يِجِيني عَدِيلْ
أُبدي دهشتي لمريم من حفظ أختي لكلمات هذه الأغنية الصعبة؛ فلا تتفاعل معي….أسألها عن والداي؛ فتشير برأسها نحو يمين الصالة حيث أبي يجالس بانسجام صديقه عم حسين ووالد عريسي، المزينة لرأسه عمامة بيضاء تفوق ضخامة عمامة الفنان كمال ترباس…..ثم توجهني للناحية الأخرى من الصالة؛ فألاحظ انهماك أمي برفقة أم ياسمين في توجيه فريق العمل المسؤول عن توزيع العشاء.
أسألها باستغراب:
– لماذا لم أرهم إلا الآن؟
تجيب من بين شعاع عينيها الماكرتين:
– لأنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
ينتابني اطمئنان لعثوري على أهلي؛ فأرجع أطالع دائرة الرقص…اصطدم بنظرة ميسم أختي….تغمز لي بعينٍ كحيلة وتهديني ابتسامة من شفاه مطلية بأحمرٍ قانٍ…أتابع بدهشة رقصها مع ابن الجراح؛ ليصل انبهاري أوجه لحظة انحناءتها اللينة رمت فيها بعنقها إلى الوراء، مقلدةً لنساءٍ فاتناتٍ ساحراتٍ، انحسرت ثيابهن التقليدية عن شعورهن المُسرحة بعناية، إثر رقصهن اللين وهنَّ يرميْنَ “الشَبَّال”.
التفتُ ناحية مريم؛ لأبدي دهشتي من إجادة أختي للرقص مع حبيبيها السوداني، ولأطالبها بمرافقتي للخارج هربًا من ثقل الأجواء التي بدأت يصيبني بالدوار…لكنني أتفاجأ باختفائها من جواري؛ لأهوي في غموضٍ جديد وشعورٍ مريرٍ بالغربة.
أعود ألتفت ناحية عريسي أملًا في جذب انتباهه؛ ليتفاقم يأسي وشعوري بالغثيان عند ملاحظة انسجامه في الرقص والعرض، والاستمتاع بجلد الظهور العارية، غير آبه لعروسه الجالسة بمفردها في الكوشة…..أقرر الهرب بمفردي.
أتلفت بحذر وافرح عند ملاحظة اختفاء وجهي من شاشات العرض المنتشرة في الصالة، بعد انصباب تركيز جميع الكاميرات على تصوير الظهور الدامية لشباب “الرَكْزَة”.
بهدوء، أتسلل إلى الخارج؛ لتنتابني خفة ما أن تلفح وجهي نسمات الهواء البارد…أحسُ بأنني أولد من جديد.
بحماسٍ أتوغل أكثر نحو الخارج؛ فيغوص حذائي في العشب الرطب؛ لأوشك على السقوط لولا تمسكي بأصيص فخاري لنبتة صبار معمرة…. بخطىً متحفظة، أسير نحو الحديقة الواسعة، بعد التقاطي لزيل فستاني تجنبًا لاحتمالية سقوطٍ ثانية.
تباغت أنفي رائحة ريحانٍ ممزوجة برائحة سيجار؛ فأتلفت حولي بفضولٍ بحثًا عن مصدر رائحة التبغ…. تتجاوزني قشعريرة عند اكتشاف اختلاف كل ما في المكان حولي، وإدراكي بأنني قد خرجت إلى مكان آخر، لا علاقة له بحديقة الورود الملونة، التي تلقتنا فيها الزفة قبل قليل، عند مدخل الباب الزجاجي المؤدي للصالة.
تتضاعف دهشتي عند ملاحظتي لقصرٍ عتيقٍ شامخٍ في آخر الحديقة…أتعرف عليه بسهولة: “دار الحجر”. ينتابني فرح واستغراب من انتقال أحد الأماكن التاريخية في صنعاء لحي الزمالك بالقاهرة…تتحول دهشتي لتوجسٍ عند رؤية أسراب خفافيش تجوب الأجواء…أتراجع خطوة للوراء بنية العودة إلى صالة الفرح؛ لأتفاجأ باختفاء الباب حيث خرجت، واختفاء الأصيص ونبتة الصبار، رغم صوت الفنانة المواصل الصدوح بأغنية “الفزع”.
أستجمع شجاعتي وأتقدم نحو القصر، أملًا في الاحتماء به، من غرابة الجو من حولي. أتعثر في خطواتي؛ بسبب خفضي لرأسي تفاديًا للخفافيش، بينما صوت الفنانة يصم أذناي بكلمات أغنية “الفزع:”
“السودان بِخِيره فيهو رجال بِغِيروا،
كَتَّرْ ألف خِيرُوا يا جَنَا“.
بنفسٍ لاهث وقلبٍ يلهج بالدعاء، أتجاوز شجرة ضخمة أمام مدخل القصر؛ لأدلف إلى الداخل…تخترقني رائحة نفتالين نفاذة تضاعف من توجسي…تعاودني فكرة الهرب من جديد…أهم بتنفيذها لولا أن يستوقفني صوت أنين، ظننته مواء قطة في البداية، قبل أن أتبين أنه صوت انسانٍ يناديني باسمي ويرجوني أن أفتح له الباب؛ لكي أحرره من سجنه.
استعيذُ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم أتلو المعوذتين وقل هو الله أحد بصوت عالٍ، دون أن يهدأ روعي.
يتحول خوفي إلى فضول لما يباغتني الصوت بسؤال:
– “هل نسيتِ “كِشْ مَلِكْ”؟
يدفعني الأدرينالين لصعود الدرجات ركضًا؛ لهفةً لمعرفة أسباب حبس صديق طفولتي في هذا المكان الموحش.
بأنفاسٍ متسارعة، أصعد خمسة طوابق؛ لأشعر، كلما اقترب الصوت، بقلبي يكاد يقفز من صدري….أصل أخيرًا إلى غرفة في آخر الطابق السادس؛ فأتوقف خلف بابها لالتقاط أنفاسي قبل أن تنفرط أشواقي وعتابي:
– افتقدتك كثيرًا يا وضاح، كم اشتقت إلى عينيك وابتسامتك وجنونك ولعبنا سويًا! لماذا لم تسأل عني طوال هذه السنوات؟ لماذا ليس لديك حساب فيس بوك أو انستجرام أو أي وسيلة كانت ستمكنني من الوصول إليك؟
يأتيني بصوته باردًا:
– هذه هي الحياة، أحيانًا يلزمنا عمرًا كاملًا لنعثر على أحبابنا الحقيقيين. وقد لا نعثر عليهم ابدًا.
أقمع نفسي لئلا أسترسل في اللوم؛ فأضيع الوقت بدل اقتناصه لأملي بصري بوجه صديق عمري بعد غياب سنواتٍ طوالٍ لم أنسه فيها.
بيدٍ راجفةٍ، أُدير مقبض الباب، لأتفاجأ بأنه مغلق بالمفتاح….أسأل صديقي عنه؛ فيجيبني بتهكم:
– ابحثي عنه جيدًا! فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
أتلفت حولي بغيظٍ، قبل أن أهتدي لأنظر تحت قدماي؛ لأعثر أخيرًا على مفتاحٍ صغيرٍ في حجم قرط أذنٍ، ملتصقًا بطرف زربية خضراء كنتُ أدوس عليها.
بلهفةٍ، أنحني لالتقاطه بأنامل مضطربةٍ متلهفة لأن تتشابك مع أنامل صديق الطفولة وحبيب الروح.
وفي أثناء مصارعتي لأشواقي، واجتهادي لإدخال المفتاح في ثقب الباب، يأتيني صوته لائمًا معاتبًا باردًا مستنكرًا، استعجالي في الزواج من أجل إرضاء أمي وأختي….تلجمني المفاجأة وتمنعني من سؤاله كيف عَلِم بتفاصيل زواجي الذي لم تكتمل مراسمه بعد…..ومن جديد، أجد نفسي أصارع ألغازًا أخرى في هذه الليلة الغريبة.
يطول الصمت المربك من خلف الأبواب؛ فيكسره وَقْعُ خطواتٍ متسارعة تصعد الدرج، وأنفاسٍ لاهثة تسابق أصواتٍ غاضبة ترغي وتزبد….أتبين صوت أمي يناديني مزمجرًا: شمس؟ إنتي فين؟، ثم صوت أم ياسمين يوبخها شامتًا لائمًا لها على عدم احسانها لتربيتي، حتى أجرؤ على الهربِ في يوم زفافي…يسمرني الخوف في مكاني….ثم أفيق من صدمتي عند اقتراب الخطوات؛ لأعاود محاولة استخدام المفتاح الصغير.
بأعجوبة، أنجح أخيرًا في إدخاله في ثقب الباب.
لكن للأسف، في اللحظة التي يُفتح فيها الباب، تدركني أمي وجارتها؛ لتمسكا بي وتصرخان بصوت واحد:
– فين الفستان؟
أُنزل بصري على جسدي لأصاب بالدهشة عند اكتشافي أن ثوب الزفاف الأبيض قد تحول لثوب صنعاني تقليدي مزركش بالأسود والأحمر يرسم تفاصيل جسدي النحيل بدقة.
وبينما أمي وجارتها تسحبانني بقوةٍ على سيراميك أرضية الدَرَج، التفت لأُلقي نظرة من فوق كتفي؛ أملًا أن يخرج وضاح ليحلق بي؛ لأقع في حيرة أكبر ولغزٍ جديد عند اكتشافي أن من يقف وراء الباب يطالعني بعدم اكتراث ليس صديقي كما كنت أظن، بل فتاةٌ تشبهني، وكأنني أنا.
بهستيريةٍ، أصرخ ملئ حلقي:
– من أنتِ؟
فتجبيني بالقهقهة دون أن تحرك ساكنًا.
يتردد صدى صراخي في أرجاء القصر، تارةً يُطالب شبيهتي أن تنقذني من يدي أمي وجارتها، وتارةً يرجوها أن تفسير سبب تخفيها رواء صوت وضاح، وتارة يلعن هذه الليلة.
يجف ريقي من الصراخ، وتخور قواي؛ فاسقط متدحرجة في السلم الأفعواني، طابقًا وراء طابقٍ.
وقبل ارتطامي ببلاط الطابق الأرضي، أستيقظ على يد ميسم تهزني بعنفٍ:
– شمس! شمس! إصحي يا شمس، شمممممس!”