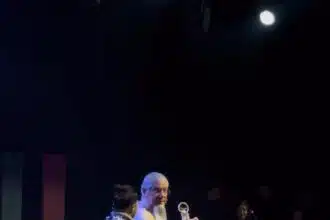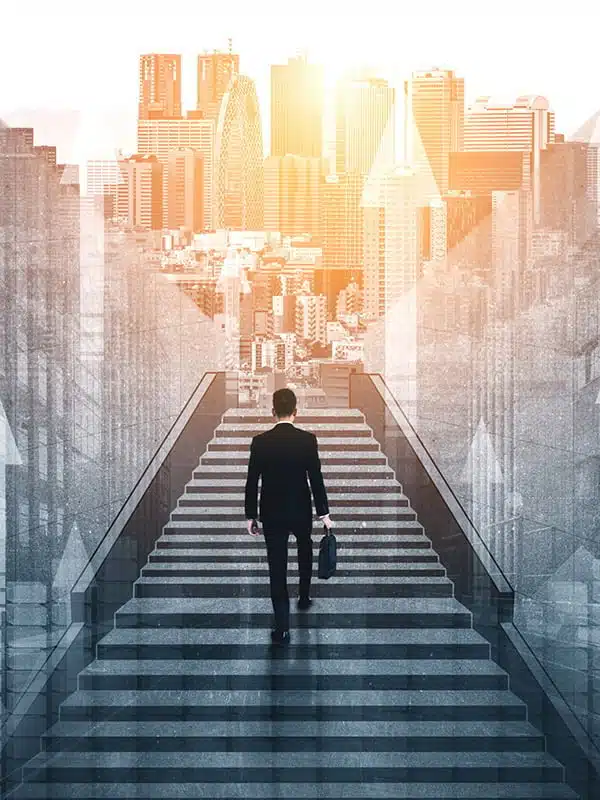سوسن إسماعيل
“الجغرافيات الحزينة للحدود الإنسانيّة”بول ايلوار
تدور أحداث القصة المعنونة بـ “12 آذار” للكاتب أحمد إسماعيل إسماعيل، في مدينة صغيرة، تستفيقُ ذات صباح، على فوضى عارمة تغطي كلّ مساحاتها الواسعة، إذ ينتفض أهلها، فتخرجُ كامل المدينة بنسائها وشبابها وشُيّابها، ويعمُّ الخوف أحياءها وساكنيها، وفي أحد الأحياء الشعبية الفقيرة، تقضي أحد الأمهات ليلتها في خوف وقلق على ابنها الذي خرج لعمله منذ الصباح، ولم يعد بعد، حتى يدقّ الطارقُ عليها البابَ في صباح اليوم الجديد.
1 ــ الكائن والمكان في النصّ القصصي:يُشكّلُ العنوان التكنيك الأول الذي يتوجب فيه على القارئ لأيّ عمل أدبي، أنْ يتقنَ القراءة فيه، ولاسيما إذا كان عنواناً قائماً على الزمنيّة، فـ “12 آذار” العنوان بجزأيه الرقمي واللفظي، لا يحملُ إلا إشارات الزمن، يحدّدُ لك التاريخ بعينه، وليس أيّ تاريخ ــ إنّهُ الثاني عشر من شهر آذار ــ كُردياً يُمثّلُ الشهر الأكثر فرحاً وألماً ــ ولكثير من الشعوب، شهر الفرح والاحتفالات بالربيع وبداية فصل وسنة جديدة ــ كما لدى الفرس ــ ولكنه لكُرد سوريا، يحملُ هذا الشهر بين صفحاته، تاريخ انتفاضة صارخة ودمويّة هزت مدينة “قامشلو”.
والقارئ المتمعّن في العنوان، لا يمكنهُ البتة؛ أن يفصل الزمان عن المكان، فحقيقة أيّ نصّ، يستوجبُ السؤال عن زمكانية الأحداث التي جرت وما زالت تجري، إذ لا يمكنُ للقارئ أن يجزّئ بين الزمان والمكان كوحدتين متلازمتين في النصّ الأدبي، وكعلاقة قائمة بينهما على المحايثة، فلا يمكن لأحدهما أن يكون مفعّلاً دون حضور الآخر، فليس ثمّة أزمنة دون أمكنة، فهما يعملان دائماً في إطار واحد، ويشكلان معاً عناصر مهمة في عمليّة السرد، ومن التقنيات التي تُبنى عليها العمليّة الإبداعية، والمحركُ الأساسي نحو القراءة، فالقراءة هنا ليست في العنوان؛ كعتبة أوليّة للنّصّ القصصي، ولا في زمكانيتها الفيزيائيّة، بقدر ما هي قراءة أبعد ما تكون في الذاكرة الزمنيّة، التي يستدعيها هذا العنوان، ما يستقطبُ القارئ هنا، هي العلاقة التي تربطُ بين هذا العنوان كزمن، مع المكان/ المدينة التي اشتعلت في هذا التاريخ، يقول القاص “بعد نهارٍ ضاجٍ أشبه باحتراق حطبٍ جافٍ في أتون نار، هبط الليل على جسد المدينة”، فالسرد يبدأ بالزمن، هو نهارُ الثاني عشر من آذار، ولأول مرّة منذ زمن بعيد، هبتْ انتفاضة زلزلت الأرض في مدينة قامشلي/ قامشلو، ثمّ لتطالَ الانتفاضة الجغرافيا الكردية كافةً، فالتحوّلات التي طالت المكان والكائن في المدينة، كانت عميقة جدا وطارئة، فما عادت الأمكنة مألوفة كما كانت من قبل “لم تستطع الظلمة إخفاء الحطامُ المتناثر في الشوارع كإشلاء، وافترس النشيج المكتوم خلف الأبواب الموصدة بإحكام”، ولا احتفظت المدينة بهدوئها، فكلّ ما فيها أصابها القلق وتحوّلت إلى نيران لا تنطفئ، وتحوّلت العلاقة مع المكان ـ هنا ـ إلى علاقة غير ثابتة، تتعرضُ لجملة من الإشكاليات والصعوبات، إذ العلاقةُ باتتْ تعاني الفوضى والقلق “في شارع ضيّق ومعتم، تلاصقت بيوته الطينيّة والإسمنتية الواطئة، استحالتْ الأبواب إلى أفواه بكماء، باب حديدي صغير تآكلت حوافه، ونخر الصدأ إطاره”، فالقاص يُصبغُ على المكان حسيته، وخاصة الأمكنة التي يشعرُ فيها المرء بالانتماء، أمكنة لها عيون تُراقب طيلة زمن طويل، بعد حالة من الثبات والسكون الذي كانت تعايشه، فيتوقفُ الإنجازُ في ذلك المكان، وتتحولُ الحركة والانتماء إلى فعلٍ مُخيف ومُربك “تلقي امرأة نظرات سريعة ووجلة على جانبي الشارع الغارق في صمته وعتمته، عدا إضاءة شحيحة تسقط من مصباح عمود كهربائي وحيد”، المكانُ يرسمُ لنفسه برنامجه الجديد، ليصبحَ برنامجاً للجميع، الكلّ يسيرُ على نهجه، فما عادت العلاقة معها ذا شجن، وما عاد المكان آمناً، ها هي المدينة تنتفضُ على بكرة أبيها “الأمواج البشرية وهي تتدافعُ في شوارع المدينة، حاملة جثامين فتية صغار وهي تطلق الصيحات الغاضبة، وتلوح بالرايات واللافتات، غير آبهةٍ بالرصاص الهاطل عليها بغزارة ولا بالخوذ الحديدية التي ملأت الفضاء وحجبت أشعة الشمس”، بقدر ما تحوّلت العلاقة بين الكائن والأمكنة، إلى علاقة يتشاركُ الكلُّ فيها، ثمة قلق عام طال الجميع، قلق داخل المكان وخارجه، كما في حركة الأم الدائمة والقلقة من/ إلى الباب ” تغمغم بكلمات قليلة، تكمُّ فَمها بيد مرتجفة، وما إن يتناهى إليها صوت سيارة مسرعة، أو وقع أقدام، حتَّى تنكفئَ إلى الداخل بخوف، تسندُ ظهرها إلى الباب المغلق، وترفعُ إلى السماء وجهاُ ضارعاً كساه الخوف بلون كامد، وقبل أنْ تُعيد الكَرّة، وتطل على الشارع بوجهها الذي راح يذوب كشمعة، تندفع نحو ابنتيها اللتين لم تكفا عن البكاء منذ غروب الشمس طلباً للطعام، تنهرهما، تصفعهما كما لم تفعل من قبل، آمرة إياهما بالسكوت، ثم تنطلق بعدها نحو باب الدار”، فالمكان في تحوّل وقلق يشارك كائنه، الباب يُفتح ويُغلق، فـ “الأفكار والقصص التي نتخيّلها أو قصص نسمعها عن الآخرين، لا نستطيعُ فهمها إلا من خلال تصورها في إطار مكاني واضح”، وبعدَ أن افتقدَ المكان لأمنه وهدوئه، باتت كلّ الأمكنة مصدر للخوف والرهبة، فالابن/ شيار لم يعد إلى البيت، خرج منذ فجر هذا اليوم لعمله في السوق، ومكانه آمن، فالأم لا تخشى غيابه، لأن هذا الغياب والتأخير يعني لديها ولدى أختيه، بأن الأخ/ شيار، قد فازَ بعمل إضافي ــ فالزمن هنا كان فوزاً ــ لذلك كانت الأم “ترفعُ وجهها نحو السماء وتتمتمُ بكلمات الشكر، وتفركُ شقيقتاه أكفهما بانتظار القطعتين النقديتين اللتين ستحظيان بهما، لتنطلقا بعدها، بإقدام تسابقُ الريح نحو دكان العم حليمو”، ولكن ثمّة تحوّل في المكان، استدعى حالة من الخوف والرعب، بعدما كان مكاناً للفرح، فالزمن الأول كان علامة فوز ومال، أما الآن فالزمكان يمثّل الخوف، بعدما طالَ الخراب المدينة، بدأت الأم تستذكر مشاهد الصباح في السوق “في منتصف المدينة، حيث ينتصبُ تمثال قائد البلاد، أمام مركز الجمارك الكائن شرقي المدينة، وفي أمكنة أخرى”، ازداد خوفها على ابنها/ شيار، وهي تتخيّلُ وقائع اليوم “تتخيلُ صور فتية يتخبطون في الشارع بدمائهم كطيور ذبيحة، أغلقت عينيها بأسى، فشاهدت تحت جفنيها صور ابنها وهو مُلقى في زنزانة معتمة، وشرطي أمرد يسوطُه بعنف”، فغيابه يثيرُ القلق، ربما تحوّلَ مكان عمله، هو الآخر من مكان مطمئن إلى مكان مُثير للخوف، فبات مكاناً ينهضُ هو الآخر بالذعر، وبذلك تتحولُ الأمكنة إلى بؤرة للأحداث فقط، كما في الثاني عشر من آذار.
العلاقة بين الكائن والمكان، هي علاقة قائمة على الرفض، وعليه فصورة المكان، ينالُ من القارئ أيضاً قيمة اجتماعية، ثقافية، وسياسية، أمكنة تُسجلُ نفسها، كأمكنة للرعب، وبذلك تساعد في فرز فكر الشخصية تجاه الخوف والقلق، وهذا ما شهدته الأم صباحاً، إذ طرأ عليها الخوف، نتيجة الخراب الحاصل في المكان/ المدينة، فزاد من هاجس خوفها على ابنها، لذلك ومن داخل الدار، فجأة ترتمي خارجه، إذ “قذفت بنفسها خارج الدار، في الشارع الذي كان خالياً، أطلقت نداء أشبه بالصراخ، انفرجت أبواب ونوافذ، وأطلتْ من خلالها وجوه وبرقت عيون، مسحت عتمة الشارع الطويل أشكالها وألوانها، وأضفى التوجس عليها لونه الباهت”، فالمكان يُشكّل الجغرافية الخلاقة في العمل الفني، وهو جزء من الحدث وخاضع خضوعاً كليّا له، فهو وسيلة لا غاية تشكيليّة ولكنها وسيلة فعالة في الحدث”، فبتحولاته الطارئة، يسهم في الأحداث ويكتشفها، وذلك من خلال التحولات التي طالت كلّ الكائنات، وكأن التحوّلات عائمة على كلّ الأشياء، هي بنفسها “وفي فم الباب، تحوّلت إلى تمثال من شمع، وهي تنظر بعينين دامعتين إلى ابنتيها اللتين افترشتا أرض الغرفة ونامتا”، فالقاص لا يرصدُ كلّ ما يعتري كائناته من الخارج فقط، إنما يهتمُ بالتفاصيل النفسية أيضاً، فالأم شاردة الذهن وهي تفترش مكانها في الشارع ” استمر تعاقب الصور أمام ناظريها، ولم تتوقف حتى اقتحمت صورة غريبة شريط الصور، كانت ابنتاها تبكيان في هذه الصورة، وهما تطلبان الطعام، فنهضت من مكانها كالملسوع، ولم تجد أحداً من الجيران حولها، دخلت الدار وهي تنادي ابنتيها بصوت مشروخ، وتوجهت من فورها إلى المطبخ، لتصنع لكل واحدة منهما شطيرة رب بندورة، وتنطلق بهما بلهفةٍ إلى الغرفة، وضعت في يد كلّ واحدة منهما شطيرة، واستلقت بينهما وهي تحملق في السقف الطيني بنظرات تائهة”. للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو كوسيط يؤطّر الأحداث، “إنه يتحول إلى محاور حقيقي ويقتحمُ عالم السرد محرراً نفسه هكذا من أغلال الوصف”.خارج الباب/ يكمن مكان الخوف، وداخله ثمة إحساس بالراحة والطمأنينة، وكأن الزمن مُعلقٌ بين الداخل والخارج، فبعد ما كانت المدينة تحملُ لساكنيها الألفة والحماية، ها هي تواجههم بإعصار، ولابُدّ من الحذر، فما عادت للمدينة فضائلها، وها هي تضربُ بيدٍ من حديد، وتحتاج لزمن حتى تستعيدَ ألفتها وطبيعتها، إنّها تتحوّلُ اليوم إلى زنازين مجهولة. الأمكنة ما عادت مغلقة، إنها تضيعُ في ظلال من الرماد، الرمادُ الذي يشتتُ في هويات كائناتها/ التمثال الذي يتربعُ هناك وسط المدينة، تحرك وسقط، وتراكم بقايا جسده على الأرض، كلّ النوافذ موصدة، الشوارع غارقة في العتمة، الصمت وراء قضبان النوافذ. إنها طاقة من السعادة والحزن، شكل من أشكال التحوّل في آن واحد.
المعطيات المكانية هنا في النصّ ــ البيت ــ هو جذر المكان، ومنه تنطلقُ الذاكرة والشخصية/ الأم ــ شيار/ الابن إلى الأمكنة الأخرى، فالقاص تناولَ المكان تناولاً عاليّاً، يجعلُ من المتلقي/ القارئ يستفحل في خياله المكاني ويستعيد كلّ أمكنته الأليفة أو حتى المعادية، فالباب يُمثّلُ للأم باب الخلاص “ثمّة قرع على الباب، كان شديداً ومتواصلاً، انتفضت من مكانها وانطلقت نحو باب الدار”، الباب الذي من ورائه يشكل التحوّل الأكبر، ببزوغ الفجر الجديد على المدينة، الباب الفاصل بين زمنين ومكانين، فاعتماد القاص على تقنية الوقفة الوصفية، في المشهد الأخير من القصة، أبطأ من الزمن، على حساب الاستطراد في السرد “أمام الباب، الذي فتحته، وبقيت في الداخل، نصفها الأسفل مثبت خلف الباب، ونصفها الأمامي مندفع إلى الأمام، كأنها صورة من يهمّ بمغادرة الصورة”، فالنصف المخفي وراء الباب/ هو الداخل الخائف والمرعب من ليلة الأمس، أما النصف الأمامي المندفع للخارج، فهو الخارج الطارئ والمتحوّل الأكبر لدى الكائن/ العائد إلى البيت، ولكن بهيئة وهويّة مختلفة، قادم جديد، لا يشبه الأمس، فما عادت الأم تلك المرأة كما كانت بالأمس، حتى يكون هذا القادم الجديد من الخارج، مثل الذي غادر فجر الأمس من داخل هذا البيت.
الأحداث تمرُّ في بعض المنعطفات وبإيقاع زمني طبيعي “اتسعت عيناها دهشة، انحبست أنفاسها وهي تتأمّلُ بدهشة ممزوجة بسرور وراح يتعاظم، هيئة هذا القادم الذي أذاب غيابه ليلة أمس روحها”.
وهنا بؤرة التحوّل الذي أصاب الكائن/ شيار، فبخاتمة عجائبيّة؛ ينهي القاص الأحداث، وكأنها حدثت في أعوام مضت، باتكائه على زمن جديد، لا يشبه ما مضى “أحالَ هذا النهار الجديد كلّ شيء فيه، إلى ما كانت ترجو أن تراه يوماً، قبل أن يوافيها الأجل”، فالمتواليات السردية، قد لا تنتظم في “المجرى الخطي السردي، قد تعود للوراء أو على العكس من ذلك تقفز للأمام لتستشرف ما هو آت أو متوقع من الأحداث وفي كلتا الحالتين نكون إزاء مفارقة زمنية”، كحالة الابن/ شيار، فثمّة إشارات أوليّة؛ بأنّهُ قد تهيّأ لما هو مقبلٌ عليه، فالمرحلةُ والمكان بضجيجه، قد منحته النضج، إنّهُ يتحرر من الزمن الفيزيائي إلى زمن أكثر ذاتيةً. إنّ حركة الزمن ــ كعنصر تشويقي ــ يتعرض للكسر والتسريع خلال عمليّة السرد، وكأن الحاضر في السّرد، ثلاثي الأبعاد، كما سماه بول ريكور، بحاضر الماضي، وحاضر الحاضر وحاضر المستقبل، وكأن الزمن مضطرب، غير منضبط، أو خارج عن المألوف فأحيانا يسترجعُ السارد بعض الأحداث، ثم نراه يستبق إلى الأمام، فالأمل يهيمنُ على الخطاب “بزغَ فجر وليد، وصبغ بلونه الوردي أسطح المنازل، والنوافذ الموصدة، والشوارع الملأ بالحطام”، فعملية السرد لا يمكنُ أن تسيرَ للأمام خارج إطار الزمن. يُقال “إنَّه على الناقد عندما يسعى إلى سدّ أغوار أيّ نصّ أدبي، ينقبُ فيها، عليه أن يبحثَ عن قيم ثلاثة فيه، الصدق، الإخلاص، والإنسانية”، والنصّ القصصي المعنون بـ (12 آذار) يحملُ هويته وجواز سفره لهذه القيّم، ولكلّ قراءة نقدية، تاركاً الأبواب المغلقة والخائفة، والنوافذ الموصدة، والشوارع المعتمة، تنهضُ من العنفِ الذي مُورسَ عليها، وتبقى مفتوحة للشمس والنور، علّها ترممُ في الذاكرة الكردية/ السوريّة.
إنَّ التردد على هذا النصّ القصصي، كفيل بأن ينتشلَ القارئ من الحذر المغلق إلى السّر الذي لم يعدْ غافياً، بقدر ما هو إعلان عن الفرادة واليقظة النّوعية في تاريخ الكرد، وتاريخ سوريا عامة، حتى حملتهُ الأقلام لمنصتها الإبداعية والكتابيّة والتداول فيه، كدلالة ومعنى لتخليد تاريخٍ كان عاليّاً في حضوره.