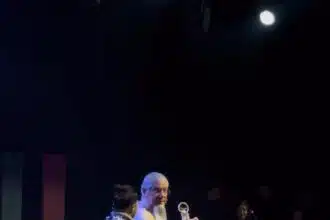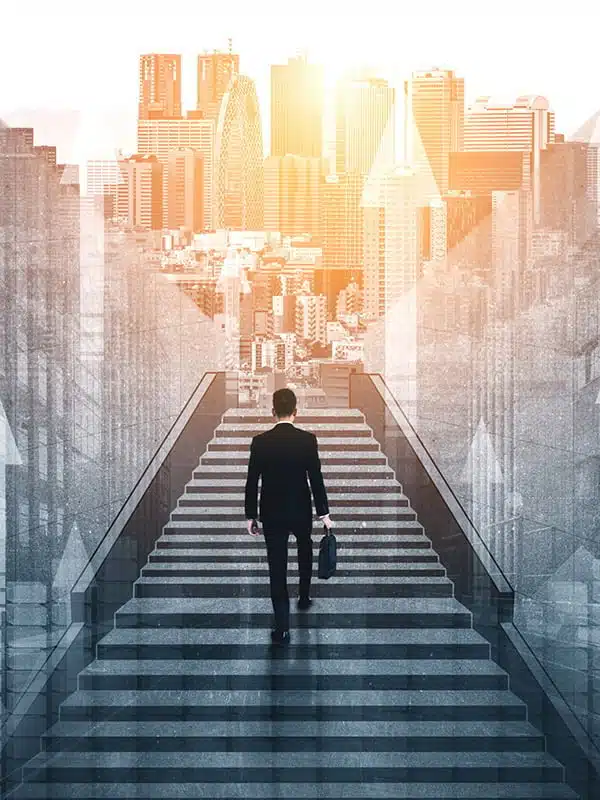جان كورد

منذ بدايات التاريخ البشري، والبشر في كل بقعةٍ من المعمورة في خوفٍ وهلعٍ من الكائنات الأسطورية التي نسجوها بأنفسهم ونفثوها في ثقافاتهم المختلفة، ومن تلك الكائنات ما هو عملاق وأخطبوط وذوات رؤوسٍ عديدة، ومنها ما ينفث النار فيحرق أسوار القلاع وسكان المدن والغابات، كما يخرج بعضها من أعماق البحار ليلتهم السفن ومن عليها… وإحدى أشهر تلك الأساطير الإنسانية، هي “الأوديسا”، الجزء الثاني من إلياذة هوميروس اليونانية الشعرية عن حرب طروادة، إذ تتيه في البحر سفينة المنتصرين العائدين من حربهم التي انتصروا فيها بالحيلة على الشعب الطروادي وتظل لسنواتٍ عرضةً للأمواج العاتية وهجمات الوحوش الخيالية الضخمة وهي تعبر المضائق التي تعصف بها الرياح الشديدة وتبرز لها غيلان الأساطير الخرافية…
إلاّ أن معظم أساطير الرعب والخوف من أهوال الطبيعة في التاريخ ظلّت في حدود مناطق محدودة من العالم، مثل بلاد الاغريق وروما وبلاد الفرس والميديين والهند والبلاد الشرقية، أو في أفريقيا، ومصر بشكلٍ خاص، أمّا عن أساطير العرب فلا نعلم عنها الكثير، سوى بطولات عنترة بن شداد التي لا يصدّقها العقل، كما لا نعلم عن أساطير الأتراك سوى أسطورة الوليد الذي أرضعته ذئبة رمادية، فأخذوا عنها شعاراً طورانياً عنصرياً مقيتاً، حتى أن الإسلاميين الأتراك كالقوميين الفاشيين يرسمونه في طلعاتهم السياسية وغير السياسية، وحسب المؤرخ الألماني الكبير ألكسندر فون ﮔلايشن-بوسفورم في كتابه الشهير (تاريخ ثقافات وعادات الشعوب – الجزء 21-22 – ص 383-385 – طبعة غوتنبرغ فرلاغ – فيينا- هامبورغ- زيوريخ) فإن الأتراك لم يضيفوا لتاريخ ثقافات الشعوب أي شيء، سوى أن امتطوا الخيول وشهروا السيوف وقضوا على الكثير من الثقافات الإنسانية والشعوب…
إلاّ أن كل التراث الأسطوري للبشرية لم يتمكّن من توحيد البشر جميعاً لمواجهة الوحوش الخيالية التي نسجتها عقولهم، سوى هذا الكائن الذي لا يرى بالعين والذي يسمونه بالكوفيد 19 المتحور بين الحين والحين بحيث لم يعد بالإمكان السيطرة عليه كما يبدو… وهنا يقف الروائي الشهير إبراهيم اليوسف ليكتب لنا عن معركته التاريخية وساحتها وضحاياها وأبطالها روايته الجديدة التي من عناصرها الأهم خوفه من أن ينقلب في لحظةٍ إلى ضحية، والتي هي بمثابة “جرس إنذار” للبشر، في معركة لم تحسم بعد، رغم كثرة الضحايا البشرية التي فقدها العالم في حربه المشتركة وتحالفه العظيم ضد هذا “الكويئن” غير المرئي…
هذه الرواية التي أبطالها وضحاياها من مختلف الملل والنحل، شحنها الروائي القدير بالكثير من ذكرياته التي جلبها معه من الوطن في حين ترك وراءه كتبه ومسوداته حيثما حط رحاله في محطات حياته، كعادته في الروايات السابقة، تعتبر ملحمةّ شبه شعرية من 330 صفحة، لا تدعك تأخذ استراحة وأنت في خضم قراءتها، ففي كل صفحة تجد خنادق الحرب الشاملة لمواجهة هذا العدو الشيطاني الظالم، العمارة التي تكاد تفقد كل أسبوعٍ أحد ساكنيها، درج الطوابق الذي يتم غسله بهوس، الحمامات، الأبواب التي يتم تعقيمها مثل كل شيءٍ آخرٍ في البيت، النوافذ التي لا تفتح، حتى الكتب ومقاعد الباص الخالية من المسافرين، وأخطر منها جميعاً، الصعود بالمصعد الكهربائي الذي للكاتب عنه ذكرياتٌ مريرة، واستهزاء الأولاد بأبيهم المرتعب الذي يكاد ينظر إلى جوف قبره وهو جالسٌ على حافته الباردة… كل ما في ساحات المعركة التي تبدو “أطولَ يومٍ في التاريخ” غارقٌ في الصمت، فالشوارع ومحطات المترو والباصات خالية، في حين تعج المستوصفات والمستشفيات بالزوار، منهم مرضى الكورونا ومنهم الخائفون، أنصاف الأحياء، الذين لا يدرون كيف يتفادون رؤية الأحبة المصابين بالمرض، فيهرعون إلى الأطباء عساهم ينقذونهم من هذا المارد الأسطوري، عفواً الحقيقي، الذي أرعب العالم من الصين واليابان شرقاً إلى كاليفورنيا والمكسيك غرباً، وهم في هرويهم إلى الأمام يختلقون المئات من الإشاعات والأكاذيب والأساطير عن الجيران والأقارب البعيدين الذين سقطوا في ساحات الوغى، ضحايا هذا المجرم الذي يحصد أرواح البشر…
طبعاً، لا نستطيع سرد الرواية في هذه النظرة أو القراءة السريعة، وهذا ليس من حقنا، ولكن نتساءل: لماذا هذه الرواية بالذات، فهي تزيدنا قشعريرةً في المفاصل وكآبةً في النفس وخوفاً فوق خوف… هل هي مجرّد صورة لما يجري الآن من حولنا؟ أم “جرس إنذار!” للبشرية، تحسباً لكوارث أعظم، مثل حرب نووية كبرى لا تبقي ولا تذر؟ أو خوفاً من انتفاضةٍ عارمةٍ للطبيعة الغاضبة على بني البشر فتقضي عليهم، أو أنها تعكس مكنونات القلب من الذكريات والرعب الذي في جوف الإنسان من الموت القادم بلا شك؟
حقيقةً، أقف بإجلال أمام مشاهد الذكريات التي تعصف بهذه الرواية أكثر من الرعب الذي تقذفه في النفوس ونحن في مقاومتنا البشرية لهذا الكويئن الذي مرّ الكثير من أمثاله عبر التاريخ، ومن شاكلته غزوات المغول والتتار والصليبيين وما أطلقوا عليه أسم “الفتوحات والأنفالات!” التي راح ضحيتها الملايين من الناس، وكذلك حروب الإبادة للعديد من الشعوب والأقوام في شتى أنحاء العالم… فذكريات الروائي التي حمل خزائنها معه من بلاده إلى أوروبا مثيرة حقاً وهي ثريةٌ بالعبر والأفكار، تكاد تشكّل “ثقافة شاملة” يلفها الإضطهاد والحرمان والشغف المستمر بإيجاد حياة بلا وحوش خرافية وأوبئة قاتلة ونظم أخبث من جراثيم الكوفيد 19… إنها رواية ليست كالروايات الكلاسيكية التي قرأناها لمختلف عظماء الروايات العالمية، فالأبطال فيها جنودٌ معظمهم مجهولون يقاتلون في الخندق الأوّل للبشرية ضد الفيروس الشرير، والمعلوم منهم جيرانٌ أو أفراد العائلة أو معارف منتشرون في الأرض أو من دفتر الذكريات، ومنهم من يسقط شهيداً في ساحة الكفاح الإنساني المشتركة ضد خرافات عصرٍ يمكن إطلاق اسم “عصر الكوفيد 19” عليه دون تردد، فالعالم لم يعد كما كان قبل انطلاق أوّل خبرٍ عن هذا الكويئن من مدينة “ووهان” الصينية. وصحيح أن التغيّرات الكبيرة في المناخ وتضخّم حجم السكان العالمي والجوع والفقر والحروب، كل ذلك لم يتمكّن من توحيد جبهتنا، إلاّ أن الإنسانية، كما يتطرّق الروائي إبراهيم اليوسف في عمله الرائع هذا، قد أضطرت لتتوحّد ولتقف خلف الأطباء ومساعديهم وعمال النظافة والوقائيين والحكومات الظالمة أو العادلة في شتى أنحاء العالم لصد “كوفيد 19” وما سيليه من غزوات الكائنات الدونية القادرة على اختراق كل الحدود لمهاجمتنا وتعطيل استمرارنا في الحياة… فهل سنشهد تدوين روايةٍ في المستقبل عندما تغزونا سفن الفضاء من كواكب أخرى، أم أن هذه الحرب هي الأخيرة في تاريخ البشرية؟