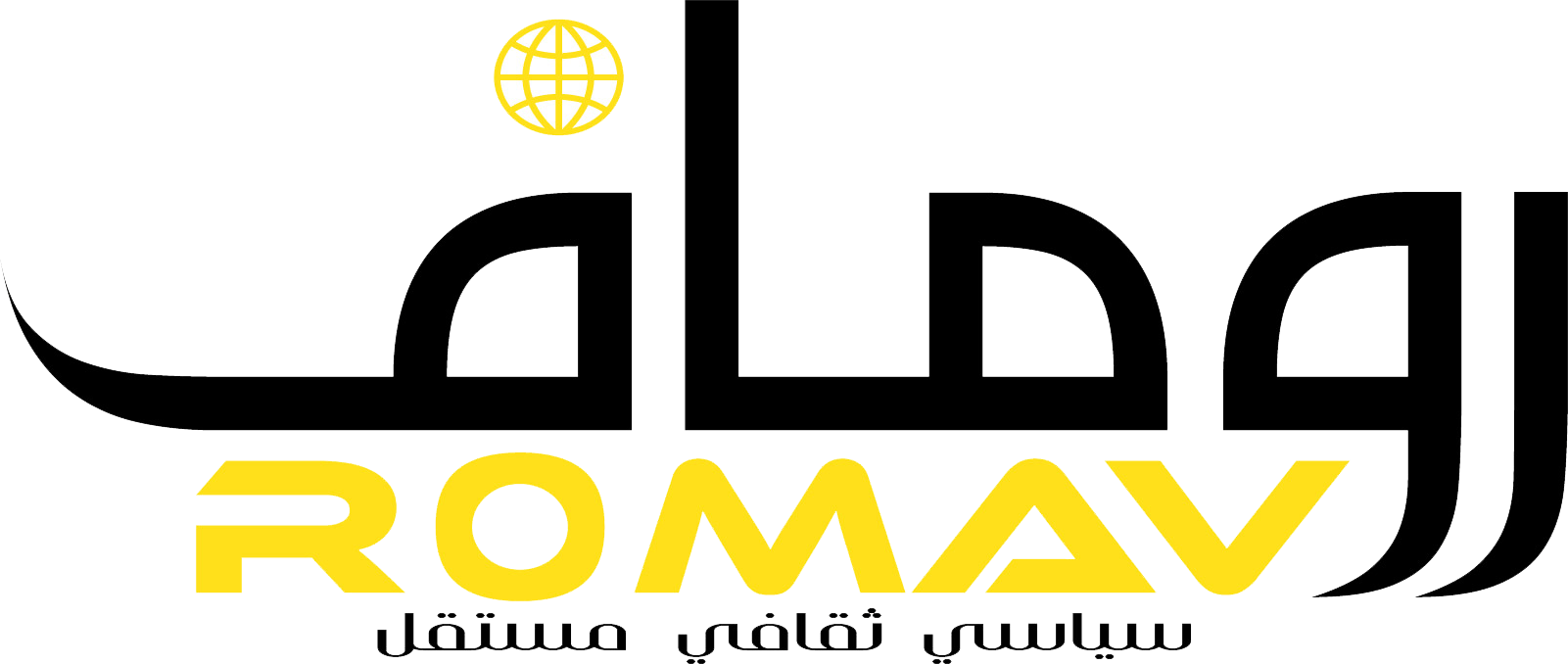ماهر راعي
شاعر من سوريا، في رصيده ديوانين شعريين؛ “مرمية هكذا
في الهواء” عن دار أرواد 2014، ” مغطس بالشوكولا” عن دار نينوى بدعم من الصندوق

العربي للثقافة والفنون 2019،
إحدى صدماتي الكبرى، والمتأخّرة نوعاً ما، كانت عندما رأيت بأم عيني أحد الأولاد يلعب البلياردو، بينما كان الخصم والده.
هذا المشهد صادفته في أحد المنتجعات البحرية، كنت وقتها من بين عمّاله الموسميين. كانا يتحديان بعضهما بطريقة حلوة، فثمة ضربات لا يقوى الصغير على تنفيذها ليقوم الأب بمساعدته، تماماً مثلما تمسك الأم يد صغيرها في واجبه المدرسي الأول، عندما تظهر له معجزة كتابة الهمزة في حرف الألف.
تابعت مشهد الأب والابن حتى النهاية، حيث فاز الصغير بفارق كرة واحدة وبضربة كانت من تنفيذ الأب. استندت إلى طاولة قريبة أراقب مشيتهما حين غادرا المكان، تاركين ضحكات لذيذة وملونة لازالت تقفز مع الكرات على طاولة اللعب.
دمعت عيناي! لم يكن هناك وقت لأتأمل الموقف بدقة أكبر وأجيب نفسي لماذا بكيت؟! كان عليّ أن أسرع لإيصال الطلب إلى طاولة زبون ملحّ وكريه… كنا نكره الزبائن، حتى اللطفاء منهم، لأمر لا يفهمه أحد.
ثمة استراحات مسروقة يمكنك فيها أن تمرّر الوقت بطريقتك، لك مثلاً أن تقضم بعض الحلويات المرتجعة من صحون زبائن غادروا للتو، يدهشك أنهم لم يلمسوا حلوياتهم الشهية، تلك التي دفعوا ثمنها رقماً يكاد يساوي نصف مرتّبك تماماً. تراقب زبونة حلوة تضحك مع حبيبها، ربما حبيبها، أو تراقب بدقة، مثل قنّاص متمرّس، متى ستنحسر بلوزتها قليلاً كلما تحركت مع الضحكة، لينكشف جزء أوسع من نهديها العارمين، أنت في زاوية معتمة تحبس أنفاسك بينما هي وحبيبها في الضوء والصخب والفرح يضحكان. في تلك الاستراحة المسروقة، ليلة لعبة البلياردو وفوز الصغير على والده المبتسم، كانت صدمتي كبيرة، فالآباء وبكل طبيعية يشاركون أطفالهم ألعاباً محرّمة!
كانت الحياة ثلاث كلمات فقط: أكل، نوم ودراسة. ليس في قاموس الأهل كلمة ترفيه، سوى حضور ساعة كانت مخصصة لأفلام الكرتون عند الظهيرة، زيارة الأقارب في القرية يوم العطلة ومن ثمّ زيارة أضرحة الأولياء الصالحين التي تعشقهم أمي
تذكرت كيف كنا ندخل ونخرج من صالة البلياردو المعتمة، في قبو رطب ونتن في حيّنا، عندما كنا في المرحلة الابتدائية في الثمانينيات من سوريا، الضيّقة على كل شيء، كان الأمر أشبه بالتسلّل إلى وكر عصابة، أو الدخول إلى بيت دعارة. كنا نعود إلى بيوتنا ملوثين بالذنب والخطيئة، لكننا فرحون بانتصار وحيد، لا يخص المنافسة على الكرة السوداء في ضربة مدهشة، حيث تتدحرج نحو حفرتها الأخيرة لتحسم الفوز… كان انتصارنا الوحيد الذي نعوّل عليه ببساطة: ألا يلمحنا أحد من الأهل أو الجيران بينما نخرج من وكر المتعة والرذيلة.
سرقتُ قلم ديمة، زميلتي في الصف السادس. يومها أعطاني أبي ثمن قلم جديد أظن أنه يكفي ليكون أجر وقت أطول في الصالة، في اليوم التالي سُرق القلم من حقيبتي، لا أحد في الكون يستطيع اكتشاف السارق لكنك تستطيع التخمين، إنه شخص يشبهك تماماً، اليوم في الصالة سيُغدق على رفاقه، ويدعوهم ليلعبوا “game” إضافي على غير العادة.
كانت الحياة ثلاث كلمات فقط: أكل، نوم ودراسة. ليس في قاموس الأهل كلمة ترفيه، سوى حضور ساعة كانت مخصصة لأفلام الكرتون عند الظهيرة، زيارة الأقارب في القرية يوم العطلة ومن ثمّ زيارة أضرحة الأولياء الصالحين التي تعشقهم أمي، أولئك الذين، ولفترة طويلة، كنت أعتقد أنهم أعلى شأناً ومقدرة من الله نفسه.
لماذا لم يلعب أبي مع أولاده؟ فلنفترض جدلاً أنه يعتبر أن أية لعبة تحتاج المال هي مضيعة للوقت والمال معاً، وهي مجرد عملية نصب يقوم بها صاحب الصالة على أولاد الحي، ماذا عن باقي الألعاب المجانية، الألعاب المنزلية البسيطة؟!
مقالات ذات صلة
لماذا لم يكن الآباء في حيّنا يلعبون مع أولادهم، هل كان العمل يرهقهم إلى هذا الحد؟ هل كان الفقر يجعلهم في أوقات فراغهم مجرد آلات مطفأة أو معطلة، ساهمين في دخان سجائرهم وفي خبز اليوم التالي؟ هل كانت ثقافة التربية آنذاك تمنعهم من مشاركة أولادهم اللعب، خوف كسر الحواجز وحفر الأولاد لصخرة الأبوة القاسية، تلك الصلابة التي كانوا يفترضون أنها كفيلة بصنع رجال المستقبل الصعب؟
نعم في تلك الأوقات المعتمة من سوريا الضيّقة على كل شيء، علّمتهم الأحزاب النضالية بأنواعها، ذات الرايات التي لا تخلو من لون الدم، والشعارات التي تحمل قبضات مضمومة وغاضبة وسلاسل مخلوعة، الأحزاب الطامحة إلى مشهد الانقلاب الدائم، استلام زمام السلطة ومسك ميكروفون إذاعة البلد من أجل البيان الأول، علمتهم أن لا شيء يأتي بسهولة، بل كل شيء يحتاج إلى قوة (شكيمة) – كانت تعجبهم هذه المفردة- والنضال الذي لا يرتاح أبداً، وأن الخشونة تحتاج إلى تربية وبناء وصناعة ولا يمكن الاستغناء عنها. علمتهم الأحزاب النضالية كل هذا، رغم أنهم يوماً لم يكونوا إلا ورقها المحروق. لم يكن المجتمع السوري حين كنا صغاراً إلا ثكنة ممتدة كبرنا فيها. كل بيت كان ثكنة، كل أب كان عسكرياً، وإن كان نجاراً أو سماناً أو يعمل في أي مهنة كانت، حتى ثياب النوم كانت موحّدة، بأحجام مختلفة.
علمتهم الأحزاب النضالية والعسكرة أن الترفيه يجب اجتثاثه، ولا مكان هنا إلا للجدية والصرامة والنضال، وأن الألوان موجة إمبريالية مفسدة للروح الوطنية، وأن الكاكي، أو القاتم بالعموم، هو سيد الألوان
علمتهم الأحزاب النضالية والعسكرة أن الترفيه يجب اجتثاثه، ولا مكان هنا إلا للجدية والصرامة والنضال، وأن الألوان موجة إمبريالية مفسدة للروح الوطنية، وأن الكاكي، أو القاتم بالعموم، هو سيد الألوان.
انقلب رفيقي في العمل على ظهره من الضحك وظنني مخبولاً، حين رددت بكل جدية: “كنت بالمدرسة”، على سؤاله: “وين كنت من شي نص ساعة، عم يسأل عنك الميتر وفي ألف زبون بالصالة؟”.
لم يكن من السهل أن أشرح له أنني حين رددت عليه بجملة “كنت بالمدرسة” بينما أرتجف، أنني حينها كنت ساهياً، أجيب أبي على سؤاله الذي كرّره ألف مرة في جلسة تحقيق قديمة وطويلة، عقب معرفته مصادفة من عصفور قذر وواشٍ، أنني كنت في صالة البلياردو.
المصدر : رصيف 22
أقرأ أيضاً
- مرحبًا عزيزي المُغادر..
 بواسطة روماف
بواسطة رومافروماف – ثقافة
نرمين الحنيطي
مرَّ على الغياب خمسةٌ وثلاثون يومًا..
جئتُ أحملُ رسالةٌ تقول:
يُسقى الشوق بالكلماتِ البالغة وأنا هُنا
لأسقيكِ جزءً من محبتي التي لا حد لها
أُرسِلُ إليك رسالةٍ أُخرى لن تصل ..
تحملُ شوقًا بلا عِتابٍ بكاملِ وقاري وكامِل هيامي أقول أنا مُشتااااااقةٌ من رأسي حتى عظامِ أقدامي
حتى فعلتُك لم تجعل منك شخصًا سيئًا لئيمًا أمامي انتَ كما انتَ في أول مرةٍ محبوبي صاحب أكثر الوجوهِ قبولًا وأقرب من حبل الوتين للقلبِ
الشدوْ الأمتع لطبلةِ أُذني
ولو بيدي لأقول قلبُ قلبي وعُمر عُمري ،فهل للعُمرِ عمرًا وللقلبِ قلبًا!! أم أنها مشاعري البالغة قد انجرفت من جديد لتصنع لك مُرادفاتٍ جديدة مليئة بالحُب ولا تصِفه!
بالرغُم من قلةِ رؤيتي لك بما فات من أيام إلا أنني حزينةٌ على أيامٍ ستأتي لا أمل لي في رؤيتِك
عمومًا عزيزي
كُن بخير إلى أن ألقى خيرَ الوجوهِ مرةً أخرى بعد ثلاثون يومًا آخرين ليصبح هنالك خمسةٌ وستون يومًا تفصِل بين قلبي وقلب من أُحب ..
- حلم قيد الإنجاز
 بواسطة دلشا آدم
بواسطة دلشا آدمروماف – ثقافة
قال : اشتقت لك
فقلت: كيف تشتاق وكل ما جمعنا لقاءان ومقعد يتيم؟
فأجاب: هو توق الروح لتوأمها الذي لا يُرى، لكنه يجسُّ نبض الغياب .
سرحتُ بذاكرتي، ومرت أمامي مشاهد قديمة، ولحظات خفقان تائهة، ربما هو ذاك الذي طالما انتظره قلبي في الغيابات الطويلة، للحظة ترددت، غاصت روحي في التساؤلات ؟
كيف لروح أن تبقى منكسرة وهناك من يتلمس بشغفٍ اللقاء؟
وكيف لقلبٍ رغم انصياعه يبدي المكابرة فيما لايملك سوى النزوع لرغباته؟
كأن العمر لا يُقاس بالأيام، بل يُقاس بما يعتري القلب من الندوب ووطأة الخيبات .
هل حقاً ينتابنا العجز ويسيح العمر في دوامة الخذلان، حين يستغيث فيحار أي الجهات سيسلك؟
أم أن القلوب تهرم مبكراً وهي تترقب اللقاء المنشود ؟
أذكر آخر مرة ارتسمت على شفاهي ابتسامة بريئة والأيام تمضي وأنا أحاول الاقتراب أكثر وأكثر لانجاز الحلم .
فكيف لك يا توأم الروح أن تشتاق لروح تحاول أن تنجز حلماً على قارعة الحياة؟
فابتسم وقال: هو التوه في مجازات العشق ياشفيعة الروح وكل ما تبقى مجرد عبارات .
- الغدُ المُحيِّرُ
 بواسطة سوار كاباري
بواسطة سوار كاباريروماف – ثقافة
في غدنا صبّارةٌ بالأمسْ
بوّابةٌ للطّمسْ
أعجوبةٌ فاتحةُ العينينِ
مثل الكأسْ
نشتاق عالمًا من الجمال
نشتاق لحظةً كانت لنا
هل نلتقيها مرّةً أخرى؟
وهل نرى وجوه الحبّ تسعى
إذا ارتأتنا؟!
كان وهمًا أن تدير الكأسَ للمحالْ
ويلتقي الغبارُ بالخبالْ
ما ضاع ضاعْ
في غدٍ قد لا تكون جنّةٌ
وتنهش الذّئاب خبزتي
نتيجتي مقطّعةْ
معصوبةُ العينين لن ترى
إلى متى نشتاق عالمًا مفضّلًا
وكيف نلتقيه جدولًا مؤوّلًا
فقصّة الأمس ما عادت
فهل غدي لحظة النّهار تنقضي
في مذهب الأحداثِ والحرّاسِ
..
لكنّها الصّبابةُ المقنّعةْ
يجري الزّمانُ راسمًا لنا الآمالَ في غدٍ
بل إنّه الظّمآن في فيافيه العِطاشْ
لا يرى غير السّراب لامعًا
فاسعد بأقرب لحظةٍ
لا تنتظرْ
هيّئ لدنياك المسرّة قانعًا ببسمةٍ
في أحلك اللّحظاتِ
قاوم باستماتةْ
أعجوبةٌ تجري تدعو إلى الشّماتةْ
إيقاعها النّدى والقول وقت الهمسْ
يجري الزّمان عائدًا أو ذاهبًا
فلتقتنصْ مباهج الحياةِ حافزًا للنّفسْ
- فاشل!
 بواسطة عرب حوري
بواسطة عرب حوريروماف – ثقافة
ذاك الذي قال لي يوماَ أنت فاشل، قالها قبل سنوات، كرهته حينها كثيراً، اليوم أحبه وأبلغه حبي أينما كان، ذاك الذي قال لي أنت فاشل، قد يكون اليوم واحداً من ألاف المهاجرين إلى بلاد الفرنجة, يركض منذ الصباح إلى مدرسة تعلم اللغة بعد تجاوزه منتصف العمر، أو ينتظر القطار على مقعد من مقاعد المحطة للحاق بالعمل، أو قد يكون سكرتيراً لحزب ما في الوطن يخرط الشعارات البائسة وهو جالس في مكتبة مزينة بالأعلام والصور،
يبثها عبر القنوات الأخبارية الرمادية بأبتسامة ساخرة ورزاز الدم تغطي شواربه المصبوغة بلون الليل، أو قد يكون رئيساً لأتحاد من اتحادات الكتاب والمثقفين الخاوية،أو قد يكون طبيباً له عيادة مكتظة بالمراجعين القانطين المفلسين، وشهادته تزين الحائط الخلفي للعيادة، تلك الشهادة التي حصل عليها بمنحة دراسية من أحدى الأحزاب الثورية، أو من عشرين علامة منحته السلطة بعد اشتراكه بدورة مظلية، ولا ننسى بأنه قد يكون من الذين ركبوا الموجة بعد طوفان الدمار والحرب القذرة فأصبح تاجرا يحسب له ألف حساب، من القيادات والأحزاب والعشائر وتفتح دونه كل الأبواب.
أعتذر منه أشد اعتزار وأقول له: نعم أنا فاشل وقد لا يكفي كلمة فاشل، نعم عزيزي أنتَ وصلت وأنا مازلت كما أنا ولم أصل رغم محاولاتي الكثيرة للوصول، كان ينقصني الكثير عزيزي، لأنني لم أحصل على ما يكفي من فنون النفاق ولم أتقن سحر التصفيق ولا الإلمام بنسج الشعارات.
نعم عزيزي فشلت لأنني لم امتلك شيئاً لشراء أصبغة ملونة، أصتبغ بها للتلائم مع الأجواء والطقس وهذا طبيعي، فالألوان تجذب الجماهير. اللون ساحر، اللون تميّز، اللون يبهر العيون ويدخل القلوب، لون الدولار جذاب واليورو يا ويلي شو أخاذ، لهذا كان اللون منتصرا دوماَ وعبر التاريخ كله. و لهذا الثابت اندثر كالرماد في مهب الرياح ولم يبقى لي سوى مرافقة الرياح ، كي لا تُتابعَ مَسيرتَها وحيدة !
- مراجعة فيلم “باي باي طبريا”
 بواسطة Natalie Alz
بواسطة Natalie Alzروماف – فن وسينما
يبدو ان مشاعري سيطرت وتضاخمت بعد مشاهدة فيلم “باي باي طبريا” ضمن مهرجان عمان للسينما في دورته الخامسة، فكيف لا تتضاخم فهو يروي قصة تهجير الفلسطينيين ومن بعدها ممارستهم للحياة في ظل نكبتهم.
https://www.youtube.com/shorts/pHXohpFHpZ0مراجعة فيلم باي باي طبريا وبينما يهدف الفيلم لطرح رواية وقصة اربع اجيال الا انه يتمركز بواحدة وهي محورية واساسية فهي نجمة العائلة ونجمة الفيلم الممثلة الفلسطينية”هيام عباس” حيث تحاول ابنتها لينا مخرجة الفيلم في سرد حكايتها وربما الكشف عن بعض الامور العائلية في مشاهد عينية وكأننا في جلسة عند الطبيب النفسي نسترجع ذكرياتنا دون المساس في لب المشكلة، دون التطرق للموضوع ولكن كما نقول في اللغة العامية “منحوم” حوليه،
فببراعتها استطاعت لينا ان تثير فضولنا عن العلاقة المركبة بين هيام وعائلتها وخاصة أمها ولكن دون ان تتعمق، فهي لم تواجه امها ولم تحكها على البوح في “اسرار” العائلة.
تتواليى المشاهد الواحد تلو الاخر بين الحاضر والماضي، بين كميرة ابيها للينا وبين كميرتها، بين صنوات التسعين والالفنيات والسنوات الحالية، في رحلة على مدار السنين بين الأجيال حين تسترجع هيام عباس وتقرأ ما كتبته لينا في اللغة الفرنسية في مشهد اتقن تمثيله واخراجه وتعثر اختيار موسيقى مرافقة مناسبة.
اما بالنسبة للارشيف فلا بد ان نسال من اين لك هذا؟
تكمن أهمية الارشيف في هذه الحالة في السياق وسرد قصة تهجير العائلة من طبريا، فهو بالامر النادر. يملك الفيلم ارشيف عائلي غني، بالاضافة الى ارشيف يستحوذ مقاطع فيديو من فترة الاحتلال والتهجير، مما ادهش الجمهور لجودته العالية علما انه نادر جدا ان يستحوذ أخد وخاصة ذوي الخلفية العربية أو الفلسطينية على وجه التحديد وعلى هذا الاساس نرى بالارشيف المرفق كنز، لياتي الرد من مخرجة الفيلم ضمن فقرة الاسئلة، على انه تم اقتناء هذا الارشيف والذي يتبع للانتداب البريطاني الذي قام بدوره بتوثيق لحظات مهمة في حياة الفلسطينيين.
يحظى الفيلم لاقبال كبير فهو من افتتح المهرجان بعمان وفي عرضه الثاني امتلأت القاعة ولم يبقى مكان واحد فارغ، فتم عرضه في الهواء الطلق في الهيئة الملكية في شارع الرينبو، وتزامن مع عرضه صوت موسيقى صخبة من حواري عمان، وكأنه المشهد الكامل لحياتنا في الاونة الاخيرة بين الحزن والفرح.
هنالك بعض الاخطاء التقنية في عمل وثائقي من هذا النوع، فلقد امتنعت المخرجة من تسجيل المكان والزمان لبعض الصور والفيديوهات او حتى لاعلامنا بالشخصيات وكأنها تتعمد هذا الشي. بالاضافة ان بعض المباني من الارشيف لا تطابق مباني طبريا مما قد اثار بعض التساؤلات عند السينمائيين والنقاد. وعلى مدار الساعة ونصف أبحرنا بين اللغة الفرنسية والعربية، بين باريس ودير حنا بين ثقافة وتراث يبدو اننا على وشك خسارتهم. وهنا ايضا لفت انتباه البعض اصرار المخرجة استخدام اللغة الفرنسية كاللغة الاولى، لضعف لغتها العربية مما راه البعض كشيء يضعف الفيلم وينقص من رسالته.
لا شك ان الفيلم هو من افضل الممثلين لفئة فلسطينية مهمشة في الشوارع والعالم العربي، فهذة بمثابة فرصة لتعرف على الفئة الاكبر من المهجرين في اوطانهم.